8- القرآن وفقه القرآن: د. إحسان بعدراني
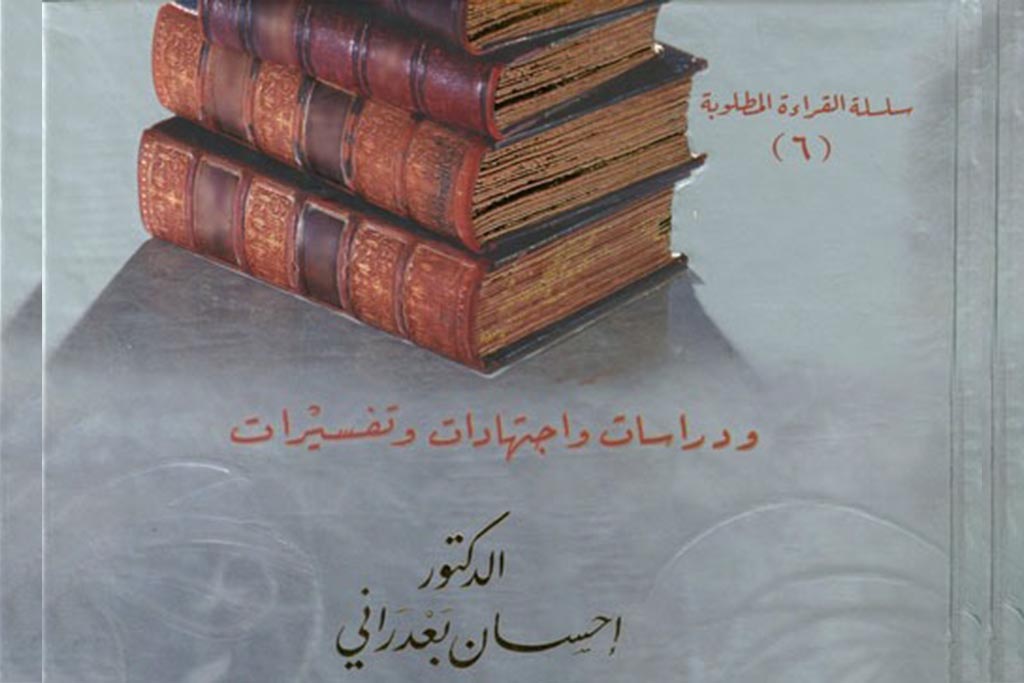
القرآن، وفقه القرآن:
قال تعالى: {إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} [الإسراء 9] .
وقال تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الزمر 28] .
وقال تعالى: {وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٖۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَكۡثَرَ شَيۡءٖ جَدَلٗا} [الكهف 54].
وقال صلى الله عليه وسلم: (( تَرَكْتُ فِيْكُم أَمْرَيْن لَنْ تَضَلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ )) [أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ، كنز العمال].
القرآن هو القاعدة، وفقه القرآن هو التطبيق، وقد يكون فقه القرآن قريباً من القرآن، وقد يكون بعيداً عنه بصور متفاوتة .
فقه القرآن صورة عن القرآن، وليس له أن يحلَّ محلّ القرآن، والتمييز بين هذين الأمرين في مجال تصدّينا له أمر ضروري .
القرآن كلام ربِّ البشر، وفقه القرآن من مفهوم البشر، والقرآن ثابت، والبشر يبعدون أو يقربون بفِقههم من هذا القرآن، ويخطئون ويصيبون في فقه هذا القرآن، وأخطاؤهم لا تُحسب على القرآن ولا تُغيّر ثوابته .
وحين يخطئ البشر في فقه القرآن فإن هذا القرآن يُظهِر خطأهم، وحين ينحرفون عنه فإنه يكشف انحرافهم، وهذا ما حصل في التعقيب القرآني على مواقف الصحابة يومَ أُحُد، والتي صاحبت رسول الله، والتي تُمَثِّلُ أكرمَ رجال الأمة على الله، وهي حقيقة، وحقيقة نافعة لنا، نتعلّم منها أن تبرئة البشر لا تساوي تشويه القرآن، ومن الخير أن يبقى القرآن سليماً معافى، وأن يوصف المخطئون بالوصف الذي يستحقونه – أيَّاً كانوا – فالقرآن أكبر وأبقى من البشر.
قال تعالى: {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ( 141 ) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ( 142 ) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }( 143 ) [آل عمران 140-143].
القرآن منهج ثابت تدور حوله حياة البشر، وبقدر فقههم لهذا القرآن وبقدر تطبيقه، بقدر ما نستطيع أن نصفهم به.
إن كشف الخطأ أو التقصير في فقه البشر للقرآن، لا يعني أنه كَشْفٌ لخطأ أو قصور في القرآن.
إن القرآن لا يعطي العصمة والكمال لأحد من البشر بعد وفاة رسول الله، ولكننا معشرَ البشر والمسلمين – في الواقع – نعطي العصمة للبشر ولبعض المسلمين، ويصعب علينا أن نرى الشخصية التي نجلّها تصيب وتخطئ في آن واحد، كما يصعب علينا القول: هذا الرأي صواب، وهذا خطأ. وكأننا أصبحنا نتعامل مع من نحب على أنهم يصيبون ولا يخطئون.
القرآن شيء، وفقه القرآن شيء آخر.
الفقيه ليس القرآن، وإنما يخضع للقرآن، وهو يسعى إلى فهمه ومعرفته والكشف عن مقصده وهدفه وروحه وجوهره. ومهما كان الفقيه فقيهاً فلن يتجاوز حدّ البشر، ثم ليس مما يقلّل من قيمة الفقيه كونه لم يُحِط بكل شيء في القرآن، وحسبه أن يعطي شيئاً ولو يسيراً، وهذا هو التقدير الحقيقي للبشر.
الهدف أن يبقى القرآن سليماً معافىً، فلا يُعرَف القرآن بالفقيه، وإنما يُعرَف الفقيه بالقرآن، ومن الصواب ربط الفقه بالقرآن، ومن الخطأ ربط القرآن بالفقه، من الصواب ربط الفقهاء بالقرآن، ومن الخطأ ربط القرآن بالفقهاء، وحين حدث هذا الأخير ظهرت الصورة الضيقة للقرآن، ظهر جانب معيّن واختفت جوانب.
هل يمكن أن يكون فقه الفقهاء معياراً للقرآن؟
لو أننا نظرنا إلى فقه الفقهاء، على عُلُوّ قدرهم وسُمُوِّ مكانتهم وعظيم اجتهادهم وسَعَةِ علمِهم بالقرآن، بكتاب الله، على أنه هو الفقه الذي ليس بعده فقه، لَأَصبَحَ بعدهم النظر في كتاب الله لا طائل منه، وفي هذا تعدٍّ على القرآن، وفي هذا أيضاً إساءةٌ لهؤلاء الفقهاء الأعلام.
مَنْ قالَ منهم: (إن أبواب الفقه قد أوصدت من بعدهم)؟
هل هذا جزاؤنا لهم على عظيم ما بذلوا وما اجتهدوا؟
أَمَا قَالَ الإمامُ مالك: (ما منّا إلا من ردَّ ورُدّ عليه إلا صاحب هذا القبر)، وأشار إلى قبر رسول الله، حين كان يلقي دروسه في المسجد النبوي الشريف.
وأما قول الإمام الغزالي: (ليس في الإمكان أبدع مما كان)، فإنه لا يتناول فقه الفقهاء كما زعم بعضهم، وإنما تشير عبارته هذه كما نرى إلى أنه ليس في قدرة المخلوق الوصول إلى إبداع الخالق في كل شيء.
قال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [النحل 8].
وقال أيضاً:{هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [لقمان 11] .
ولو قُدِّر للفقه أن يحيط بالقرآن لَتَوقَّفَ ركبُ الفقه عن أن يتقدّم خطوة واحدة، لأنه ليس بعد الوصول إلى ما في القرآن كلّه من مطلب، ولَرُفعت الأقلام وجفّ الحبر وطويت الصحف.
الفقه خطوةٌ على درب القرآن الذي لا يتناهى، وما أبعد الفرق بين أن نجعل الفقه هو القرآن، وبين أن نجعل الفقه خطوة في درب القرآن، ومع هذا فإن الفقه هو من الإسلام، وليس إسلاماً كاملاً.
إن النظر على أنّ الفقه هو القرآن نظر يسدّ الباب للسير نحو التجديد والجديد، وهذا يعني إيقاف حركة الحياة والتاريخ.
إنّ الأجيال القادمة سوف تسخر منّا إذا وقفنا عند مكيال الأجيال الماضية فلكل عصر مكيال، هل نبقى على مكيال وسواك وحبة البركة في المدينة المنورة؟ هل نقف عند الوسيلة ونترك الهدف والغاية والمقصد؟
إذا كان القرآن هو الباقي، فلم الخلاف؟ فلكل فقيه فقهه، وليس لأحد حقّ في أن يفرض علينا فقهه، وإلا كان فقهه هو القرآن.
نقول: لم يفعل ذلك أحد من قبل، ولقد رفض الإمام مالك ذلك حين طلب منه، لأنه كان يعلم أن القرآن شيء والموطّأ شيء آخر.
إِنَّ إِعفاءَ أنفسِنا من التجديد في هذا العصر إذا قامت فينا أسبابه لا يعني إلا أننا خُلِقْنَا عَبَثَاً، أو أننا أموات في أجساد أحياء، وما دام القرآن هو معيار الفقه فما هو الفقه؟
يقول الدكتور محمد عنبر رحمه الله في رسالته إلينا:
الفقه: يعني الفهم، نقول: فَقِهَ الرجلُ: فَهِمَ، ونقول: فلان
لا يَفْقَهُ: لا يفهم، ونقول: فَاَقهَهُ: باحثه في العلم ، وعلى هذا فالفِقْهُ: يعني العِلمُ بالشيء – أيّ شيء – وكل عالم بشيء فهو فقيه. والفقه: يعني أيضاً التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد، ثم غلّب الفقه على العلم بالشريعة، وقال علماء اللغة: الفقه مشتقّ من الفتح والشقّ، وعلينا إذا أردنا أن نفقه الشيء أن نشقّه ونفتحه لنعلم ما في ذاته ونفقه ما في داخله، ولئن كان الفقه يعني الشقّ والفتح، ونحن لا نشقّ الشيء ولا نفتحه ، كيف نفقهه؟ لماذا سميّ الفِقْهُ فِقْهاً؟ أليس لأننا نشقّ ونفتح الشيء المصرور؟ لنفقهه ونفهمه ونعرفه المعرفة البصيرة التي تقودنا إلى أسراره وأقداره الكامنة في ذاته والتي توصلنا إلى مقصده وهدفه وروحه.
إننا بحاجة إلى فقه الأشياء من الذرات إلى المجرات، إننا بحاجة إلى فقه القرآن من ألفه إلى يائه، ونحن بمنعرج اللوى، وعسى أن نستبين النصح قبل ضحى الغد.
ونتساءل: هل كان فيما مضى من الزمان فقه جديد مكّن الفقهاء من سلف الأمة أن يجدوا في القرآن كلّ ما يحتاجون إليه للنهوض به، من حال إلى حال، مع تغيّر الزمن وتبدل الحال، لجلب المصالح ودرء المفاسد وحل المشكلات وصلاح أمر الأمة، بحيث لم يبق جديد أو مستجدّ؟
أَمَا وَقَفَ الفقهاءُ سابقاً على مقاصدَ وغاياتِ وأهدافِ القرآن في عصرهم الواحد، ثم وجدوا ما يَحْدُوا بِهِم أَنْ يَعْدِلُوا عن أمور أفتوا بها في بعض الأماكن أو الأزمنة ليفتوا بخلافها في أماكن أخرى وأزمنة أخرى؟
الشافعي رضي الله عنه، كان له مذهبان: قديم وجديد، قديم في بغداد، وجديد في القاهرة، حين قَصَدَها سنة 199 للهجرة.
ومحمد بن الحسن بن فرقد، ناشر علم أبي حنيفة، له مذهب في بغداد، ومذهب في مرو.
إن عدول الفقيه عن رأيه الأول ليس سببه فقط تبيّن وجه الصواب من الخطأ، ولا إلى ظهور دليل كان خافياً أو قد يكون، ولكن في كثير من الأحيان إنما سببه تنقّل الفقيه في الأمصار ووقوفه على تغاير الأحوال والظروف والأعراف في الأمة الواحدة، وكلا رأييه في الفقه صحيح.
نحتاج إلى فقه جديد دائماً يشمل بأحكامه كل ما تجيء به الحياة المتجددة المتغيّرة المتبدلة من حوادث ووقائع ومستجدات، والقرآن يعطي العلاج والدواء المناسب، وإِنْ تغيّر الزمان والمكان والإنسان والحوادث والوقائع.
الثابت من الأحكام ثابت، وإن تغيّر الزمان والمكان، والمتطوّر من الأحكام متطور بتغيّر الزمان والمكان، لأن القرآن جاء لتحقيق مصالح العباد التي تتجدد، وهذا التغيّر مرتبط بالعامل المؤثر، وقد يكون العامل المؤثر ظرفاً معنوياً أو مادياً أو خاصاً أو عاماً أو ….
ونخلص إلى القول: إن القرآن فيه فقه الطوارئ، وفقه الضرورة، وفقه المستجدات، وفقه مصالح العباد، التي تجلب النفع والخير واليسر وترفع الحرج والمشقة، وهو فقه العافية بامتياز إلهي.





