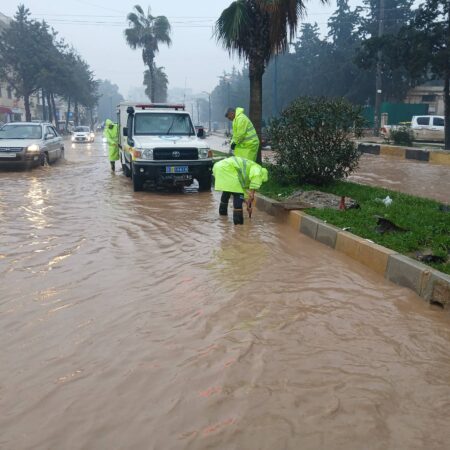المقدمة:
منذ إعلان القوائم النهائية لأعضاء مجلس الشعب في سورية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025م، بدا المشهد السياسي أمام مفترق جديد من حيث الشكل والمضمون. فهذه الخطوة، التي أنهت عمليّة الاختيار ضمن الدوائر الخاضعة لسلطة دمشق، أعادت إلى الواجهة سؤالا قديماً متجدّدا حول طبيعة المؤسسة التشريعية في الدولة السورية وموقعها في منظومة الحكم، لاسيّما في ظلّ غياب أي إعلان رسمي عن الأعضاء الذين سيُعيّنون من حصة رئاسة الجمهورية، أو عن موعد انعقاد المجلس رسميا.
هذا التأجيل الظاهر، الذي يجيء بعد أشهر من المداولات الشكلية في ملفات الانتخابات والإصلاح الإداري، يحمل في طيّاته دلالات تتجاوز الجانب الإجرائي! فهو يكشف عن حالة من التردّد بين منطق الانتظار ومنطق التأسيس، بين من يرى أن المرحلة الراهنة لا تسمح بتشكيل برلمان ذي معنى فعلي، ومن يرى أن بقاء الفراغ التشريعي أخطر من أي نقص في التمثيل أو خلل في الشرعية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى قراءة متأنية من منظور بحثي مدني ـ وطني، تستعيد المعنى العميق للمؤسسة التشريعية في أي مشروع لإعادة بناء الدولة السورية، وتبحث في دلالات هذا التوقف المؤقت، ومبررات الدعوة إلى التعجيل في تشكيل البرلمان بوصفه خطوة انتقالية ضرورية لاستعادة الفعل المؤسسي وتنظيم المجال السياسي العام.
ذلك أن التجربة السورية، خلال ما يزيد على عقد من الحرب والانقسام، أثبتت أن غياب الأطر التمثيلية الرسمية، أو تحويلها إلى هياكل صورية، لا يلغي الحاجة الموضوعية إلى مؤسسة تضبط الإيقاع السياسي وتعيد إنتاج النقاش الوطني داخل قنوات شرعية واضحة. فبين سلطة الأمر الواقع المتعددة، والفراغ الدستوري شبه الكامل، تبدو إعادة الحياة إلى البرلمان ـ حتى بحدودها الانتقالية ـ مسألة لا تحتمل التأجيل أكثر.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، نسعى هنا إلى تحليل المسألة من أربعة محاور مترابطة:
- الفراغ التشريعي ومعناه البنيوي في الحالة السورية.
- دوافع ومبرّرات الاستعجال في تشكيل البرلمان كخطوة انتقالية.
- حدود الشرعية والتمثيل في ظل غياب بعض المناطق والمكوّنات.
- موقع التيار المدني الوطني في إعادة تعريف الفعل المؤسسي.
وهو لا يتوخّى إصدار حكم مسبق على العملية بقدر ما يهدف إلى تقديم قراءة موضوعية تُوازن بين مقتضيات الشرعية ومقتضيات الفعل السياسي، وتؤكد أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من المثاليات، بل من إعادة تشغيل المؤسسات، مهما كانت منقوصة، ضمن مسار متدرّج نحو عقد اجتماعي جديد.
المحور الأول، الفراغ التشريعي ومعناه في البنية السياسية السورية:
منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، تعرّض مفهوم السلطة التشريعية في سورية إلى تآكل تدريجي على المستويين الوظيفي والرمزي.
فمجلس الشعب، الذي كان يُفترض أن يمثّل سلطة الشعب ويراقب عمل الحكومة ويشارك في صياغة السياسات العامة، تحوّل عمليا إلى جهاز مصادقة شكلي يتبع السلطة التنفيذية، ثم فقد لاحقاً حتى هذا الدور المحدود مع تصاعد هيمنة الأجهزة الأمنية والعسكرية على القرار العام.
ومع تعمّق الانقسام الجغرافي والسياسي بعد 2012م، أصبحت البلاد أمام تعدد فعلي لمصادر التشريع والإدارة! فمجالس محلية في الشمال والشرق، وهيئات مدنية تابعة للفصائل أو للإدارة الذاتية، في مقابل برلمان رسمي في دمشق يفتقر إلى الصلة الحقيقية بالمجتمع السوري المتنوع.
وفي هذا السياق، لم يعد الفراغ التشريعي مجرّد غياب لجلسات البرلمان أو تأخر في انتخاب أعضائه، بل أصبح فراغاً في الوظيفة السياسية للدولة، إذ تحوّل القرار العام إلى نتاج تفاهمات فوقية بين دوائر السلطة أو بين سلطات الأمر الواقع، دون وجود مؤسسة جامعة قادرة على تمثيل الإرادة الوطنية أو التعبير عن التعدد الاجتماعي ضمن أطر قانونية.
وبالتالي، لم يعد السؤال المطروح اليوم: هل البرلمان القادم شرعي؟ بل "هل هناك فعلاً حياة تشريعية يمكن أن تُستعاد"؟
إن هذا الفراغ ينعكس مباشرة على مجمل النظام السياسي، لأن البرلمان في أي دولة هو المساحة التي تنتقل عبرها الصراعات المجتمعية إلى مستوى الحوار المؤسسي.
وحين تغيب هذه المساحة، يصبح المجتمع أمام خيارين كلاهما خطير:
إما اللجوء إلى الشارع والعنف كوسيلة تعبير سياسي، أو الركون إلى الصمت واليأس، بما يعني تكلس الدولة وتحولها إلى إدارة بلا سياسة.
ومن منظور نظري، يُعدّ الفراغ التشريعي من أخطر مظاهر الأزمة البنيوية للدولة الحديثة، لأن الدولة لا تستقيم إلا بتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية.
وفي الحالة السورية، أدّى اختلال هذا التوازن إلى ما يمكن وصفه بـ "السلطة الأحادية المتعددة":
أحادية في المركز الرسمي، ومتعددة في الأطراف، حيث كل منطقة تشرّع لنفسها ضمن سلطات الأمر الواقع.
هذا التناقض أفرز وضعا فريدا تُمارس فيه السياسة خارج المؤسسات، بينما تبقى المؤسسات قائمة شكلياً لتأكيد "رمزية الدولة" فقط.
من هنا، يصبح الحديث عن تشكيل مجلس شعب جديد، حتى في ظروف غير مثالية كحالتنا اليوم، ذا دلالة مزدوجة:
فهو من جهة قد يُعيد بعض رمزية الفعل المؤسسي ويحدّ من تمدد الفوضى القانونية، ومن جهة أخرى يكشف عمق الأزمة الدستورية التي جعلت التمثيل السياسي في سورية إجرائياً بلا مضمون.
لكن الأخطر أن استمرار هذا الفراغ من دون أي مبادرة لإعادة تشغيل المؤسسة التشريعية، قد يعني تثبيت نمط حكم استثنائي دائم يعتمد على المراسيم والقوانين المؤقتة بدل النقاش البرلماني، وهو ما يُنذر بتحويل المرحلة الانتقالية إلى حالة بنيوية جديدة، أي إلى استبداد بلا مؤسسات، وهذا ما لا نراه هدفاً للسلطة والشعب اليوم.
لذلك، يمكن القول إن معالجة الفراغ التشريعي ضرورة سياسية وأخلاقية لضمان بقاء فكرة الدولة نفسها.
فالدولة لا تُعرَّف بحدودها أو أجهزتها فقط، بل بقدرتها على إنتاج الإرادة العامة عبر التمثيل والتشريع، أي عبر المؤسسة التي تقول باسم الشعب: "نحن".
المحور الثاني، الاستعجال في تشكيل البرلمان كضرورة انتقالية:
يبدو في ظاهر الأمر أن الدعوة إلى الاستعجال في تشكيل البرلمان السوري، والتي نتبناها في تيار المستقبل السوري، خصوصاً بعد صدور القوائم النهائية لأعضاء مجلس الشعب وعدم إعلان حصة الرئاسة حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قد تفسَّر بوصفها محاولة لتسريع إجراءٍ إداريٍّ أو تقنيٍّ في بنية الدولة.
غير أنّ القراءة الأعمق تكشف أنّ المسألة تتجاوز هذا الإطار الإجرائي لتتصل بجوهر التحول السياسي نفسه، وبالسؤال الأوسع عن كيفية الخروج من الجمود المؤسسي الذي يطبع الدولة السورية منذ سنوات.
إذ إنّ الأزمة السورية في أحد وجوهها هي أزمة تعطّل الدولة كمؤسسة سياسية جامعة.
لقد أصبحت أجهزة الحكم، بفعل الحرب والانقسام، تعمل في نطاق إدارة الأزمات لا في نطاق إنتاج السياسات العامة.
وبالتالي، فإن الدعوة إلى الاستعجال في استكمال التشكيل البرلماني ليست دفاعاً عن شكلٍ سلطوي أو انتخاباتٍ منقوصة، بل هي دعوة إلى استعادة الحركة داخل الجسد السياسي، لأن الدولة التي لا تُنتج فعلاً تشريعياً تبقى في حالة موت مؤجل.
إن منطق "الانتظار" الذي ساد في السنوات الماضية، سواء بدعوى غياب الظروف الدستورية أو بسبب الانقسام الجغرافي، لم يسهم إلا في ترسيخ ما يسميه الباحثون بـ "ثقافة الفراغ السياسي"، وهي الثقافة التي تفضّل الجمود على المبادرة، وتعتبر أن أي تحرك مؤسسي بلا شرعية مثالية أخطر من استمرار العجز نفسه.
بينما التجارب المقارنة في دول ما بعد النزاعات (مثل البوسنة أو العراق أو جنوب أفريقيا) أثبتت أن إعادة تفعيل المؤسسات، ولو بشكل مؤقت أو جزئي، هي الخطوة الأولى في مسار الانتقال السياسي، وأن الانتظار بحثاً عن شروط مثالية يؤدي غالباً إلى تثبيت الانقسام لا تجاوزه.
من هذا المنظور، يمكن القول إن التعجيل في تشكيل البرلمان السوري القادم لا يُعدّ مغامرة سياسية، وإنما تجسيد لفكرة الشرعية العملية التي تسبق الشرعية الانتخابية الكاملة.
فالشرعية في المراحل الانتقالية لا تُستمد فقط من صناديق الاقتراع، بل من قدرة المؤسسات على ممارسة وظائفها العامة وحماية فكرة الدولة من التفكك.
إن برلماناً انتقالياً محدود التمثيل، لكنه فعّال في التشريع والمساءلة وإدارة النقاش العام، أفضل بكثير من غياب كامل لبرلمان يترك القرار السياسي حبيس الدوائر التنفيذية والأمنية.
وبعبارة أخرى، إنّ الفراغ لا يملؤه الصمت بل الفعل، والفعل هنا هو أن تُستعاد لغة السياسة داخل قاعة تشريعية، حتى وإن لم تضمّ كل أطياف المجتمع بعد.
ثمّة جانب آخر يُعطي للاستعجال بعداً وطنياً حيوياً، وهو ما يمكن تسميته بـ "الوظيفة الرمزية للمؤسسة التشريعية".
فالبرلمان، حتى في حدوده الشكلية، يُمثّل عند السوريين فكرة الدولة الواحدة، الجامعة، التي تتحدث باسم الجميع، ولو رمزياً.
وفي ظل تعدد سلطات الأمر الواقع في الشمال والشرق والجنوب، فإنّ استمرار غياب البرلمان المركزي يُكرّس الانطباع بانقسام دائم، بينما تسريع تشكيله يبعث برسالة معاكسة مفادها أنّ الدولة لم تفقد قدرتها على إعادة إنتاج نفسها مؤسسياً.
إن الدعوة إلى التعجيل هنا لا تعني القبول ببرلمان مغلق أو مقيّد الإرادة، بل تعني مطالبة بتفعيل مؤسسة قائمة ضمن رؤية إصلاحية انتقالية.
أي أن يتمّ تشكيل المجلس بسرعة، لكن مع ربطه بمسار سياسي جديد يهدف إلى توسيع المشاركة لاحقا، وإلى فتح قنوات رقابة وتشاور حقيقية مع القوى المدنية المستقلة، ومع المجتمعات المحلية غير الممثلة اليوم.
بهذا المعنى، يصبح الاستعجال آلية للتصحيح التدريجي، لا لتكريس الواقع الراهن.
إنّ تجربة التاريخ السوري تُظهر أن لحظات الانسداد السياسي كانت دائما مرتبطة بتعطيل العمل البرلماني.
وفي المقابل، كانت لحظات النهوض والإصلاح، مهما كانت محدودة، تبدأ من إعادة تفعيل الحياة التشريعية.
ومن ثمّ، فإنّ الإصرار على تشكيل البرلمان في أقرب وقت ممكن لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه مجاملة لسلطة أو تزكية لإجراء، بل بوصفه نداءً وطنياً لإعادة الحياة إلى الفضاء المؤسسي للدولة، بعد سنوات طويلة من غياب الحوار العام داخل الأطر الرسمية.
إن سورية، في هذه المرحلة الانتقالية المعقدة، تحتاج إلى برلمان يعمل، لا برلمان مثاليٍّ مؤجل.
فالتاريخ السياسي لا ينتظر اكتمال الشروط، بل يصنع الشروط من خلال الفعل.
والفعل المؤسسي، مهما بدا ناقصاً، يظلّ أفضل من الاستمرار في حالة اللا فعل التي استنزفت كل إمكانات الدولة والمجتمع معًا.
المحور الثالث، حدود الشرعية والتمثيل في ظل غياب بعض المناطق والمكوّنات (السويداء ومناطق قسد نموذجًا) :
تمثل قضية الشرعية والتمثيل إحدى أعقد المعضلات التي تواجه أي عملية سياسية في سورية المعاصرة، خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب والانقسام الجغرافي والاجتماعي. فالبرلمان، بصفته التعبير المؤسسي الأعلى عن الإرادة الشعبية، لا يمكن أن يؤدي وظيفته كاملة ما لم يكن انعكاسا لتنوّع المجتمع السوري في مناطقه وطوائفه وهوياته السياسية والثقافية.
لكن الواقع الراهن يشير إلى أنّ هذا التمثيل يظل ناقصاً بفعل غياب مناطق أساسية عن العملية الانتخابية أو رفضها المشاركة فيها، كما هو الحال في السويداء ومناطق الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي (قسد)، وهو ما يضع مسألة الشرعية في موقع إشكالي يحتاج إلى قراءة دقيقة، لا من زاوية قانونية فحسب، بل من منظور سياسي – اجتماعي شامل.
- السويداء: شرعية الامتناع ومأزق الدولة.
تُعدّ محافظة السويداء نموذجاً بالغ الدلالة على ما يمكن تسميته بـ "شرعية الامتناع"، أي الشرعية التي تتولد من رفض المشاركة في عملية يعتبرها السكان غير معبّرة عن إرادتهم الحرة.
فالامتناع الجماعي في السويداء، منذ انتخابات 2020 مروراً بمحطات لاحقة، وصولاً إلى الانتخابات الأخيرة في 2025م، لا يعكس فقط موقفاً احتجاجيًاً من السلطة المركزية، بل يمثّل إعلاناً مدنياً عن أزمة الثقة بين الدولة ومجتمعها المحلي.
لقد تحولت السويداء، خلال السنوات الأخيرة، إلى رمز لتيار وطني مستقل يرفض العنف من جهة، ويرفض الخضوع لسلطة لا تمثله من جهة أخرى.
وهذا الموقف لم ينبع من نزعة انفصالية، كما حاول الإعلام الرسمي للنظام البائد وقتها تصويره، وذلك قبل دعوات الشيخ حكمت الهجري، بل من رغبة في استعادة معنى المواطنة ضمن دولة مدنية عادلة.
وعليه، فإن غياب السويداء عن التمثيل البرلماني ينبغي أن يُقرأ كـ مؤشر على خلل في شرعية المركز نفسه، الذي لم يعد قادراً على احتضان التنوع المحلي ولا على توفير إطار وطني جامع يطمئن الجميع.
ومن منظور وطني فإن معالجة هذا الغياب لا تكون عبر فرض التمثيل القسري أو إدماج رمزي لأشخاص بلا قاعدة شعبية، بل عبر فتح مسار حوار مباشر مع القوى الأهلية والسياسية في المحافظة، وتقديم ضمانات جدية لاحترام إرادة المجتمع المحلي، بما يعيد بناء الجسر المقطوع بين الدولة والمجتمع، ويمنع مشروع الانفصال الجاري.
ذلك أن الشرعية في مفهومها الأعمق لا تُمنح من السلطة للشعب، بل تُستعاد من الشعب إلى السلطة عبر التمثيل الحر والمسؤول.
- مناطق "قسد": التمثيل المعلّق بين الأمر الواقع والدولة المركزية.
أما في مناطق شمال وشرق سورية الخاضعة لـ"الإدارة الذاتية" المدعومة من التحالف الدولي، فالمشهد أكثر تعقيدا.
فهناك سلطة أمر واقع تمتلك هياكل حكم محلية ومجالس تشريعية موازية، ولها مشروعها السياسي القائم على اللامركزية الديمقراطية.
في المقابل، ترفض دمشق الاعتراف بهذه الهياكل، وتعتبرها مؤقتة أو خارجة عن الدستور، ما يجعل سكان تلك المناطق خارج التمثيل البرلماني الرسمي منذ أكثر من عقد.
هذه الحالة أنتجت ما يمكن وصفه بـ التمثيل المعلّق: فالمواطنون في تلك المناطق ليسوا ممثلين فعلياً في مؤسسات الدولة السورية، ولا هم قادرون على بناء تمثيل وطني معترف به دوليا.
وهكذا يعيشون في فراغ مزدوج: سياسي تجاه دمشق، ودولي تجاه المجتمع الدولي الذي لا يعترف بشرعية الانفصال.
لكن تجاهل هذا الواقع من قبل السلطة المركزية لا يُفضي إلا إلى تعميق الانقسام.
فالشرعية، في عصر ما بعد النزاعات، لا تُقاس فقط بمدى الالتزام بالدستور الرسمي، بل بمدى الاعتراف بالتعدد السياسي والاجتماعي داخل الحدود الوطنية.
ومن ثم، فإنّ إعادة دمج هذه المناطق في العملية التشريعية الوطنية يجب أن تكون أولوية لأي تسوية سياسية مستقبلية، لا على قاعدة العودة إلى المركزية القديمة، بل على قاعدة عقد اجتماعي جديد يُعيد تعريف الدولة كإطار تعددي جامع، لا كسلطة احتكار.
إنّ الدعوة إلى تسريع تشكيل البرلمان في دمشق، كما ورد في المحور السابق، لا يكتمل معناها ما لم تقترن بخطة موازية لفتح الحوار مع المناطق غير الممثلة، سواء عبر لجان تنسيق مدنية، أو آليات مراقبة مستقلة، أو انتخابات تكميلية لاحقة تُتيح تمثيلا تدريجيا لكل السوريين.
بهذا الشكل، تتحول الشرعية من مفهوم قانوني جامد إلى عملية سياسية مستمرة، تزداد قوتها بقدر ما تتسع لتشمل الجميع.
- بين الشرعية الشكلية والشرعية التوافقية:
إنّ غياب بعض المناطق لا يعني سقوط شرعية العملية السياسية برمتها، لكنه يفرض انتقالا من مفهوم الشرعية الشكلية إلى مفهوم الشرعية التوافقية.
الشرعية الشكلية تقوم على الامتثال للنصوص القانونية، أما التوافقية فتنشأ من القبول المتبادل بين المكوّنات الاجتماعية والسياسية.
وفي حالات النزاع الطويل مثل الحالة السورية، لا يمكن لأي برلمان أو حكومة أن تكتسب شرعية حقيقية دون هذا القبول التوافقي، حتى وإن التزمت شكليا بالدستور.
وهذا يضع التيارات المدنية، ومنها تيار المستقبل السوري، أمام مسؤولية فكرية وسياسية كبرى:
العمل على صياغة رؤية وطنية جديدة للشرعية، تربط بين ضرورة وجود مؤسسات فاعلة من جهة، وضرورة تمثيل الجميع من جهة أخرى، بما يحول دون انزلاق البلاد إلى نمط "الدولة المجزأة" التي لكل منطقة فيها دستورها وسلطتها الخاصة.
إن الدعوة التي يطرحها تيار المستقبل السوري في هذا الإطار، يمكن أن تتخذ شكل توصية استراتيجية مفادها أنّ "التعجيل في تشكيل البرلمان ينبغي أن يُقترن بخطاب رسمي يُقرّ علناً بضرورة استكمال التمثيل الوطني في مرحلة لاحقة"، عبر انتخابات أو تفاهمات تضمن مشاركة السويداء ومناطق الإدارة الذاتية والمهجرين السوريين على حد سواء.
وبذلك يُعاد تعريف الشرعية كعملية تراكمية، لا كقرار لحظة واحدة. - البعد الأخلاقي والسياسي للتمثيل:
من منظور فلسفة الحكم الحديثة، كما في أعمال يورغن هابرماس وجون رولز، فإنّ التمثيل هو تجسيد لمبدأ العدالة التوزيعية والمساواة الأخلاقية بين المواطنين.
وغياب مكونات بعينها عن التمثيل يعني عمليا أنّ الدولة تُقصي أجزاء من ضميرها الجمعي.
لهذا، فإن البرلمان الذي لا يتسع لصوت السويداء أو الكرد أو المهجّرين أو المهمّشين لا يمكن أن يدّعي تمثيل الأمة السورية بكل تنوعها.
إنّ التحدي الحقيقي أمام النخب السورية اليوم لا يكمن في إعادة توزيع المقاعد البرلمانية فحسب، بل في إعادة تعريف فكرة التمثيل نفسها لتتسع للهويات المحلية واللغات الثقافية المتعددة، ضمن إطار وطني جامع.
وإلا فإنّ الشرعية ستظلّ منقوصة مهما بلغت دقّة الإجراءات الدستورية. - نحو صيغة تمثيل مرحلية شاملة:
إن المقاربة الواقعية التي يتبناها تيار المستقبل السوري تقوم على فكرة التمثيل المرحلي التراكمي، أي القبول ببرلمان أوليّ محدود التمثيل اليوم، شريطة أن يكون بوابة لتوسيع المشاركة تدريجيا عبر مراحل زمنية محددة تتزامن مع الإصلاح الدستوري والسياسي.
هذه الرؤية توازن بين ضرورات الاستقرار المؤسسي وبين متطلبات العدالة السياسية، وتشكل مخرجا عمليا من مأزق الشرعية في ظل الانقسام الراهن.
إنّ سورية بحاجة اليوم إلى نموذج برلماني انتقالي مرن، لا إلى نموذج مثالي جامد.
برلمان يستوعب ما هو ممكن الآن، ويعترف بما هو غائب، ويضع خطة واضحة لاستكمال تمثيل الجميع.
ذلك وحده كفيل بتحويل الشرعية من شعار إلى ممارسة، ومن ورقة انتخابية إلى عقد وطني متجدد.
المحور الرابع، الانعكاسات السياسية والاجتماعية لتأخر إعلان حصة الرئاسة من مجلس الشعب السوري:
يُعدّ تأخر الإعلان عن الأسماء التي سيختارها رئيس الجمهورية لشغل مقاعد حصة الرئاسة في مجلس الشعب السوري (بحسب النظام المعمول به حاليا) ظاهرة سياسية ذات دلالات عميقة، تتجاوز الجانب الإجرائي إلى ما هو أعمق: إدارة السلطة للزمن الانتقالي، وتوازن القوى بين مراكز القرار، وموقع البرلمان في هندسة السلطة الجديدة.
إن هذا التأخر، في ظل اكتمال القوائم العامة وغياب إعلان واضح لموعد الجلسة الافتتاحية، يعكس تردّدا بنيويا بين الرغبة في إظهار مؤسسات الدولة بمظهر الفاعلية، والخشية من أن يتحول البرلمان إلى مساحة نقاشية قد تُضعف هيمنة المركز.
- بين إدارة الوقت السياسي وتجميد اللحظة الانتقالية:
في الأنظمة التي تمر بمراحل ما بعد النزاع، يمثل الزمن السياسي عاملاً حاسما في شرعية الفعل العام.
فكل تأخير في إطلاق المؤسسات التشريعية أو التنفيذية يُقرأ من قبل المجتمع المحلي والدولي كدليل على ضعف الإرادة السياسية للإصلاح أو تعثّر التحول المؤسسي.
وفي الحالة السورية، فإن تأخر إعلان الأعضاء المعيّنين من حصة الرئيس لا يمكن عزله عن هذا السياق. فهو يؤخر عمليا انطلاق البرلمان في ممارسة دوره الانتقالي، ويُبقي البلاد في حالة فراغ تشريعي رمزي، يزيد من ضبابية المشهد السياسي ويضعف ثقة المواطنين بمسار الإصلاح.
لكن؛ ومن جهة أخرى، قد يعكس هذا التأخر محاولة من السلطة لضبط توازن حساس داخل النخبة السياسية، سواء من حيث الانتماءات الجهوية والطائفية أو العلاقات الشخصية والولاءات الإدارية.
فالبرلمان، وإن لم يكن في الظروف الراهنة مؤسسة ذات سلطة تشريعية حقيقية، فإنه يشكل ساحة رمزية لتوزيع الحصص والنفوذ وإعادة تدوير النخب.
وبالتالي، فإن تأجيل إعلان الأسماء يمكن اعتباره أداة تكتيكية لإعادة رسم خريطة الولاءات قبل تثبيتها رسمياً.
- تأثير التأخر على الثقة العامة والمشهد السياسي:
من الناحية الاجتماعية والسياسية، ترك هذا التأخر انطباعا عاما بعدم الجدية في إطلاق البرلمان الجديد.
ففي ظل تردي الأوضاع المعيشية، وغياب الأفق السياسي، يتطلع السوريون إلى أي إشارة توحي بأن الدولة قادرة على الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة التحول.
لكن حين يُعلن عن انتهاء عملية اختيار النواب المنتخبين دون استكمال التعيينات الرئاسية أو تحديد موعد الجلسة الافتتاحية، يُترجم ذلك في الوعي العام كأن النظام يحتكر الحق في الوقت والمصير، وكأن الشعب ينتظر قراراً فوقيا يمنحه حق التمثيل.
هذا الانطباع يضرّ بالسلطة نفسها، لأنه يضعها في موقع الجهة المعرقلة للمأسسة، حتى لو كانت تسعى، في منطقها الداخلي، إلى الحفاظ على التوازن.
ومن ثم، فإن تسريع الإعلان عن الأسماء يخدم فكرة الدولة بوصفها كياناً منظماً لا يخشى المؤسسات.
إن تيار المستقبل السوري، من موقعه كتيار مدني وطني، يرى أن الزمن في المرحلة الانتقالية يجب أن يُدار بمنطق الاستباق لا الانتظار.
فالفراغ المؤسسي في بلد هش مثل سورية لا يُبقي الأمور معلّقة فحسب، بل يفتح المجال أمام قوى الأمر الواقع والمشاريع المتطرفة لملء الفراغ السياسي بوسائلها الخاصة.
إنّ التأخير في استكمال تشكيل البرلمان لا يُقرأ كهدوء إداري، بل كعلامة ضعف هيكلي في فهم معنى التحول السياسي ذاته.
- حسابات الرئاسة بين السيطرة والرمزية:
في تحليل أعمق، يمكن النظر إلى تأخر إعلان حصة الرئاسة على أنه تعبير عن مأزق مزدوج في علاقة السلطة بالبرلمان:
فمن جهة، تحتاج الرئاسة إلى برلمان جديد يمنحها صورة الدولة المستمرة والشرعية الشكلية أمام الخارج، لكن من جهة أخرى، تخشى من أن يتحول البرلمان نفسه إلى مساحة تطالب بقدر من الفاعلية أو المساءلة، ولو رمزياً.
وعليه، يبدو أن السلطة التنفيذية تميل إلى تأجيل انطلاق البرلمان حتى تُحكِم ضبط تركيبته الداخلية، بحيث تضمن توازناً لا يسمح بتكوّن أي مركز ضغط حقيقي داخل المؤسسة.
إلا أن هذا المنهج، رغم اتساقه مع منطق الدولة السلطوية، يتناقض تماما مع روح التحول الانتقالي الذي يفترض فتح المجال أمام النخب الجديدة، والمستقلين، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.
فالتأخير هنا إبقاءٌ متعمّد للحظة الانتقالية في حالة تجميد، بحيث يبقى البرلمان فكرة مؤجلة لا واقعا سياسيا.
من الناحية الدستورية، يمكن القول إنّ تعيين جزء من البرلمان بقرار رئاسي قد يكون مبررا في المراحل الأولى من الانتقال، لتأمين توازن سياسي ومؤسساتي.
لكن إطالة أمد هذا التعيين أو تأجيله بلا مبرر علني يضرب المبدأ ذاته، ويحوّله من أداة استقرار إلى أداة تعطيل. - القراءة الاجتماعية والنفسية: فقدان الإيقاع السياسي.
في المجتمعات الخارجة من الحرب، يشكّل "الإيقاع السياسي" عاملًا نفسياً مهماً لاستعادة الثقة العامة.
كل حدث مؤسسي — جلسة برلمان، إعلان حكومة، إطلاق برنامج اقتصادي — يخلق إحساسا بالزمن العام المشترك، ويمنح الناس شعورا بأن الدولة تتقدم.
أما حين تتعثر الأحداث بلا تفسير، تنشأ حالة من الجمود الوجداني، حيث يشعر المواطن أنّ الزمن السياسي متوقف، وأن المستقبل مؤجل دائما..
من هذا المنظور، فإن تأخر إعلان التعيينات البرلمانية لا يُقاس بعدد الأيام، بل بمقدار ما يولّده من إحباط جماعي.
وهو ما يفتح الباب أمام تراجع الثقة بمبدأ الدولة المركزية، وتعزيز الميل نحو الانعزال المحلي أو التسييس الهويّاتي، سواء في السويداء أو مناطق الإدارة الذاتية أو حتى في الشتات السوري.
وبالتالي، فإن التعجيل بالإعلان عن التشكيلة الكاملة للبرلمان الجديد يحمل قيمة رمزية وطنية تتجاوز بكثير قيمة المقاعد نفسها، لأنه يمثل إعلانا بأن الدولة ما تزال قادرة على التحرك، ولو ضمن شروط صعبة.
- من التأجيل إلى الفعل: دعوة للانتقال إلى المرحلة المؤسسية.
من منظور تيار المستقبل السوري، فإنّ أي تأخير إضافي في إطلاق البرلمان الجديد سيكون خسارة مزدوجة:
أولا، لأنه يُبقي الدولة في وضع "الانتظار الدائم"، ما يضعف قدرتها على المبادرة السياسية.
وثانيا، لأنه يحرم التيارات الوطنية والمدنية من منصة محتملة لتداول الأفكار وإطلاق الخطاب الوطني داخل مؤسسة رسمية، ولو محدودة الصلاحيات، ولو لم يكونوا بداخل المؤسسة بشكل حقيقي.
إنّ البديل عن هذا التأجيل ليس التسرع الفوضوي، بل التعجيل المنظّم والمعلن، ضمن رؤية انتقالية واضحة تُعطي الأولوية لتأسيس المؤسسات قبل الخوض في المناكفات السياسية.