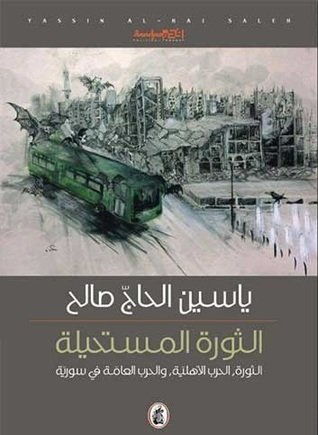مقدمة:
تُعد التجربة الماليزية في الحقبة الممتدة بين عامي 1981 و2003 تحت قيادة الدكتور مهاتير محمد نموذجاً لنجاح الدولة في إعادة صياغة هويتها الوطنية، وتأسيس بنيتها الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المؤسسي ضمن مجتمع متنوع إثنياً ودينياً. وقد شكلت سياسة "رؤية ماليزيا 2020″ التي أطلقها مهاتير نقلة مفاهيمية في فهم الوظيفة التنموية للدولة، ربطت بين القيادة السياسية الفاعلة، والإصلاح المؤسسي، والتحديث الإنتاجي الموجّه.
قبل هذا التحول، كانت ماليزيا تعاني مظاهر دولة متشظية كما يُعرّفها فوكوياما: ضعف في احتكار السلطة الشرعية، واختلال في توزيع الموارد، وانقسامات بين المكونات المجتمعية.
لكن مهاتير تجاوز هذا الواقع عبر نموذج قيادي مركب يجمع بين التنموية الاقتصادية (developmentalism)، وسياسات الإدماج المدني، وحشد الإرادة الوطنية حول مشروع مستقبلي جامع.
تتشابه هذه الانقسامات البنيوية بشكل كبير مع الحالة السورية الراهنة، حيث تعاني الدولة من هشاشة مؤسساتية، وتصدّع مجتمعي، وغياب التوافق على صيغة وطنية جامعة. ومع ضرورة الحذر من النقل الميكانيكي للنماذج، فإن الفلسفة التنموية التي انتهجتها ماليزيا تقدم إطاراً تحليلياً قابلاً للتكييف في سورية، وخصوصاً في ملفات بناء المؤسسات، وإعادة تعريف الهوية السياسية الجامعة، وتحويل الانقسام إلى تنوع مُنتج ضمن هوية وطنية متعددة.
هذا المقال ينطلق من مدخل فلسفي سياسي مقارن، لتحليل تجربة التحول في ماليزيا، ويركز على السياسات الجوهرية التي أحدثت الفرق، مثل التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الاقتصادية، والإدارة العامة الفعّالة، ويرتبط بالسياق السوري عبر تقديم مقترحات منهجية بحسب رؤية تيار المستقبل السوري، لتأسيس مسار إصلاحي مستدام، مبني على الدروس المستخلصة من مدرسة مهاتير، ومن النماذج التنموية الآسيوية ذات الاستقرار المؤسسي.
"إذا أردت بناء أمة عظيمة، فابدأ ببناء الإنسان الذي يؤمن بها." – مهاتير محمد (Mahathir, 1995)
الخلفية التاريخية والسياسية لماليزيا قبل مهاتير محمد.. دولة تعددية ذات هشاشة بنيوية وتحديات تراكمية:
قبل وصول مهاتير محمد إلى السلطة عام 1981، كانت ماليزيا دولة متخمة بالتحديات الهيكلية، تجمع بين التنوع الإثني والديني والمناطقي، والانقسامات الاقتصادية العميقة، وصراع هويات سياسي لم يُحسم حتى ذلك الوقت. يُمكن اعتبار ماليزيا في تلك المرحلة مثالًا كلاسيكيًا للدولة النامية التي خرجت لتوها من الاستعمار، لكنها لم تنجح بعد في بناء مشروع وطني جامع.
الإرث الاستعماري والاختلالات المؤسسية:
منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1957، ورثت ماليزيا نظامًا إداريًا هشًا يعتمد على البيروقراطية الاستعمارية دون أن يكون مدعومًا بقاعدة اجتماعية متماسكة. كانت الهياكل الحكومية موجهة أساسًا لخدمة المصالح الاقتصادية للبريطانيين، ولم تُبنَ لتستوعب التعدد الإثني الداخلي، حيث شكل الملايو حوالي 50% من السكان، والصينيون 30%، والهنود 10%، بالإضافة إلى أقليات محلية أخرى.
الصينيون، الذين سيطروا على مفاصل الاقتصاد في المدن الكبرى، أصبحوا في نظر العديد من الملايو طبقة مهيمنة اقتصاديًا لا تمثل الهوية الأصلية للبلاد، مما خلق توترات بنيوية انعكست في سياسات التوظيف والتعليم والنشاط التجاري.
أحداث العنف العرقي، صدمة 1969:
واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا كانت أعمال الشغب العرقي في مايو 1969، التي اندلعت بعد الانتخابات العامة وأسفرت عن مئات القتلى (غير مؤكدة رسميًا)، عندما احتج الملايو على هيمنة الصينيين في البرلمان والاقتصاد. وقد أعلن بعدها حالة الطوارئ، وتوقف العمل بالدستور مؤقتًا، وشكلت الحكومة وحدة جديدة أسمتها "المجلس الوطني للعمليات" (National Operations Council) لإدارة الأزمة، مما أدّى إلى إعادة رسم النظام السياسي بشكل جذري.
أثبتت تلك الأحداث أن ماليزيا غير قادرة حينها على إدارة التعددية الإثنية دون تصعيد، وأن فكرة الدولة القومية كانت في أزمة شرعية عميقة.
فشل النمو الاقتصادي التوزيعي:
رغم معدلات نمو متذبذبة في الستينات والسبعينات، فإن الفجوة بين الريف الذي تقطنه أغلبية الملايو، والمدن التي يهيمن عليها الصينيون، كانت تتسع. وقد أدى ذلك إلى تصاعد المطالب بسياسات تمييز إيجابي لصالح الملايو، تجلت في ما يُعرف بسياسات "النظام الاقتصادي الجديد" (New Economic Policy – NEP) التي بدأ تطبيقها عام 1971، تحت قيادة عبد الرزاق حسين، وكانت تهدف إلى:
- القضاء على الفقر، بغض النظر عن الانتماء العرقي.
- إعادة هيكلة المجتمع بحيث لا ترتبط العرق بالوظيفة الاقتصادية.
لكن هذه السياسات رغم أنها خفّفت جزئياً من حدة الفوارق، فقد خلقت مناخًا من الريبة بين الأعراق، وشكّلت نقطة ضغط دائم على النظام السياسي لاحقًا.
أزمة القيادة والشرعية قبل 1981:
بحلول نهاية السبعينات، كانت النخبة الحاكمة تفتقر إلى شخصية قيادية قادرة على تجاوز الانقسامات، وكان النموذج السلطوي–الوظيفي عاجزًا عن حشد طاقة اجتماعية إنتاجية. كما عانت البلاد من فساد إداري متراكم، وتراجع في كفاءة المؤسسات العامة، وغياب واضح للرؤية التنموية الشاملة، في وقت بدأت فيه الدول الآسيوية المجاورة (مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة) الانطلاق في مسارات تحديث قوية.
عند المقارنة بسورية، نلحظ تماثلًا في بعض المعضلات البنيوية، منها:
١- تعددية مجتمعية لم يُدار تنوعها ضمن هوية وطنية جامعة.
٢- ضعف في الشرعية السياسية المرتبط بفقدان الإجماع الوطني، خصوصًا مع وجود الانقسامات الطائفية والعرقية.
٣- تراكمات اقتصادية مناطقية بسبب سياسة النظام البائد تُعمق التفاوتات وتحبط جهود التنمية.
٤- عجز مؤسسي في توظيف الإرث الثقافي والتاريخي لبناء اقتصاد تشاركي منتج.
من هنا، يصبح فهم الخلفية الماليزية قبل مهاتير مدخلًا جوهريًا لأي محاولة لتطبيق نهج تنموي في سورية، خصوصًا في ضوء الحاجة لتجاوز السرديات القائمة على الانتماء نحو مشروع إنتاجي–مؤسساتي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها منصة للعدالة والتنوع.
نحو بناء الدولة التنموية ذات الرؤية:
في سياق التجربة الماليزية، لم يكن التحول الذي قاده مهاتير محمد مجرد مشروع اقتصادي عابر، بل مثّل انقلابًا على نموذج الدولة ما بعد الاستعمار، التي غالبًا ما تعاني من فوضى مؤسسية وتبعية خارجية وفشل في توليد السيادة من داخل المجتمع. ومهاتير، رغم خلفيته غير النخبوية -كطبيب ثم وزير للتعليم والصحة- امتلك قدرة استثنائية على الربط بين فلسفة الحكم وإعادة تصميم السوق، الإدارة، والهوية.
بعكس النموذج الثوري الذي يسعى إلى إسقاط النظم السابقة، اعتمد مهاتير إصلاحًا تراكمياً، يُبنى على ما هو قائم مع إعادة توجيه وظيفي. لم يُلغِ المؤسسات الموروثة من الاستعمار، بل أفرغها من محتواها النخبوي، وأعاد تعبئتها بوظيفة وطنية إنتاجية، يمكن القول أن مهاتير مثّل نموذج "الحاكم التقني – السياسي"، إذ تعامل مع مؤسسات الدولة كمنصات تنفيذ لا أدوات هيمنة، مستفيدًا من تقنيات الحوسبة والإدارة اليابانية ودمجها في بناء إدارة عامة فاعلة.
ومن أبرز مظاهر براعة مهاتير في القيادة كان نهجه في إدارة الأزمات. في أواخر التسعينات، عندما ضربت الأزمة المالية آسيا، رفض مهاتير توصيات صندوق النقد الدولي التي دعت إلى تعويم العملة الماليزية، وبدلًا من ذلك فرض ضوابط على رأس المال وأبقى على سعر صرف الرينغيت مستقرًا.
وقد عبّر الاقتصادي جوزيف ستيغليتز (الحائز على نوبل) عن إعجابه بهذا النهج معتبرًا أن "ماليزيا كانت من الدول القليلة التي تحدّت المؤسسات المالية الدولية بنجاح دون انهيار".
هذا التصرف زاد من شرعية مهاتير داخليًا، إذ رأى فيه المواطن الماليزي زعيمًا يحمي اقتصاد البلاد لا يخضع للضغوط الخارجية.
واجه مهاتير المؤسسة الحزبية الحاكمة (UMNO) بإصلاح داخلي لا تكسيراً سياسياً. وأعاد تشكيل المكتب التنفيذي وفرض قيودًا على المحاصصة، وأجبر الوزراء على تقديم خطط مرحلية لكل وزارة وفق مؤشر أداء. وقد اتهمه خصومه بالتسلط، لكنه أعاد تعريف مفهوم "الكفاءة" كمصدر للشرعية بدلًا من الانتماء الحزبي أو القبلي.
إن تجربة مهاتير في إصلاح "القيادة السياسية من الداخل" تصلح كنموذج لدول عربية يعاني فيها الحزب الحاكم من الترهل والجمود، حيث أن "مهاتير لم يحارب المؤسسات، بل غيّر منطق عملها".
وفي خطابه أمام البرلمان الماليزي عام 1995، شدّد مهاتير على أن "العدالة ليست فقط توزيعًا، بل هي تمكين للمواطن من الوصول إلى الموارد عبر الجدارة"، وهو ما يعكس تداخله الفريد بين المضمون الأخلاقي والسياسي.
وقد استشهد مفكرون بهذه المقولة في وصف الفرق بين التنمية الرأسمالية والتنمية الوطنية.
في هذا الإطار، أعاد مهاتير صياغة علاقة المواطن بالدولة: لم يعد المواطن متلقّيًا للمنح، بل شريكًا في بناء الدولة. ومؤسسات مثل وزارة التعليم والتخطيط أصبحت مسؤوليات اجتماعية، لا مجرد أجهزة تنفيذ.
من خلال ما سبق، يمكن لسورية أن تُهيكل بعض هذه المبادئ ضمن خطوات قابلة للتنفيذ:
١- بناء هيئة تخطيط سيادي تُنتج سياسات تنموية قائمة على مؤشرات لا على الولاءات.
٢- رفض سياسات الإملاء الدولي من المؤسسات المالية دون بديل داخلي مؤسسي، مع الانفتاح على الخبرات الآسيوية.
٣- إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة العامة والمواطن، عبر تحميل المؤسسات مسؤولية بناء القدرات لا احتواء الأفراد.
٤- تطوير سياسة حكومية قائمة على "الجدارة مقابل التمكين"، بوصفها بديلاً للنهج الريعي أو الزبائني.
الانفتاح السوري – الماليزي وممكنات التعاون المؤسسي.. من دراسة النموذج إلى بناء شراكة تنموية متعددة الأبعاد:
بعد تحليل تجربة التحول التنموي الماليزي في عهد مهاتير محمد، تبرز أهمية تحويل هذه الدراسة من مجرد تقويم فكري إلى مشروع تعاون عملي بين سورية وماليزيا. ورغم أن المسافة الجغرافية والسياسية بين البلدين قد تبدو واسعة، إلا أن التحديات المتشابهة -ولا سيما ما يتعلق بإعادة بناء الدولة بعد الانقسام، وإحياء الاقتصاد الإنتاجي، وصياغة هوية وطنية جامعة – تُمثل نقطة ارتكاز لمقاربة استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين.
ولعل مبررات التعاون السوري–الماليزي تتجلى بـ:
- تشابه التجربة المجتمعية، فلقد عاشت ماليزيا انقسامات إثنية حادة بين الملايو والصينيين والهنود، كما تواجه سورية تحديات طائفية ومناطقية مماثلة، ما يجعل إدارة التعددية الماليزية نموذجًا قابلاً للتأمل السوري.
- نهج التنمية الموجّهة بالهوية، فماليزيا لم تنجح فقط اقتصاديًا، بل في بناء "هوية تنموية جامعة" عبر سياسات شاملة في التعليم والإعلام، وهو ما تحتاجه سورية بشدة في إعادة التأسيس بعد سنوات الحرب.
- الانفتاح على الدول الإسلامية الآسيوية، فماليزيا، كونها فاعلًا في منظمة التعاون الإسلامي، تستطيع أن تلعب دورًا جسرًا بين سورية والدول الصاعدة اقتصاديًا مثل إندونيسيا وبنغلادش، بعيدًا عن الاستقطاب الجيوسياسي التقليدي.
وأما مجالات التعاون العملي فتتمثل بـ:
- إصلاح الإدارة العامة وبناء القدرات المؤسسية، عبر تنفيذ برنامج تدريبي مشترك بين وزارة التنمية الإدارية السورية والمعهد الماليزي للإدارة العامة (INTAN)، يركّز على التحول الرقمي، مكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات. إضافة لتبنّي نموذج "وحدة التخطيط الاقتصادي الماليزية" (EPU) كمثال لإنشاء هيئة سورية مستقلة للسياسات المتكاملة.
- التعليم الفني والتقني، من خلال التوسع في الشراكات بين الجامعات السورية والمؤسسات الماليزية مثل جامعة التكنولوجيا الماليزية (UTM) وجامعة العلوم الإسلامية العالمية (IIUM)، خصوصًا في مجالات الهندسة، والحوكمة، والدراسات الاجتماعية. إضافة لإنشاء "المعهد السوري–الماليزي للتنمية التطبيقية" لتدريب الشباب على المهارات التقنية وسلوكيات سوق العمل.
- المنطقة الحرة السورية–الماليزية، عبر تأسيس منطقة صناعية حرة مشتركة في الساحل السوري، تستقطب رؤوس الأموال الماليزية في مجالات الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والنسيج. إضافة إلى اعتماد تشريعات ضريبية تحفيزية مستلهمة من تجربة منطقة بينانغ الصناعية (Penang Free Zone).
- الزراعة الذكية والأمن الغذائي، عبر تطوير مشاريع تعاونية بين وزارتي الزراعة تهدف إلى إدخال تقنيات الزراعة الماليزية القائمة على الاستدامة والتحكم الرقمي، مع دعم خطوط تصدير مشتركة إلى جنوب شرق آسيا.
لهذا فهناك حاجة كبيرة لجهود مؤسسية لتعزيز التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الاقتصاد السورية ووزارة التجارة الدولية الماليزية، تتضمن خارطة طريق لعشر سنوات.
وتشكيل مجلس تعاون سوري–ماليزي مشترك يتكون من مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، وأكاديميين، وخبراء تنمية، يرفع توصيات سنوية للقيادتين.
إضافة إلى تبنّي برنامج تبادل الخبرات، يشمل إرسال الوفود السورية إلى ماليزيا للاطلاع على تجربة مهاتير في التنمية، والإدماج، والإصلاح المؤسسي.
يُبرهن النموذج الماليزي أن نجاح أي دولة خارجة من الأزمة يعتمد على القدرة على تبني رؤية تطويرية ذات طابع مؤسسي، يتكامل فيها البُعد الفني مع السياسي، والهوية مع الاقتصاد. وإذا استطاعت سورية أن تبني شراكة استراتيجية مع ماليزيا لا تقوم على الاستيراد، بل على التمكين والتبادل والخبرة المنهجية، فإن ذلك يشكّل مدخلًا واقعيًا لرؤية تنموية سورية 2040.
نحو رؤية سورية مستلهمة من التجربة الماليزية لإعادة بناء الدولة والمؤسسات والمجتمع:
بعد استعراض التحول التاريخي الذي قادته ماليزيا في عهد مهاتير محمد، وما تحقق من نتائج تنموية ومؤسساتية، يكتسب الحديث عن إمكانية تبني مقاربة إصلاحية في سورية طابعًا عمليًا، خصوصًا بعد أكثر من عقد من الصراع والانقسام.
كما تستدعي المرحلة الراهنة رؤية وطنية طويلة الأمد، تتجاوز الآليات الإدارية التقليدية، وتعتمد على فلسفة التحول التنموي والمجتمعي التي تُعيد تعريف دور الدولة والمؤسسات من جديد.
وعليه فإننا في قسم البحوث والدراسات في المكتب السياسي لـ تيار المستقبل السوري نوصي بما يلي:
أولاً: صياغة رؤية وطنية شاملة تقوم على:
- اقتراح اعتماد "رؤية سورية 2040″ كوثيقة استراتيجية رسمية، تُبنى عبر حوار وطني يشارك فيه خبراء اقتصاديون، وإداريون، وتربويون، وممثلون عن المجتمع المدني، على غرار "رؤية ماليزيا 2020″ التي وضعت مؤشرات محددة للتنمية والاندماج.
- تطوير هذه الرؤية بحيث تشمل مجالات إعادة هيكلة المؤسسات العامة على أساس الكفاءة، وتحديث التعليم وتوطينه وظيفيًا، وترسيخ الهوية السورية الجامعة ضمن ثقافة الإنتاج والتنوع، وتحقيق تنمية مكانية متوازنة بين الريف والمدن.
ثانيًا: إصلاح الإدارة العامة والحوكمة ويكون عبر:
- تأسيس هيئة مستقلة شبيهة بـ "وحدة التخطيط الاقتصادي الماليزية" (EPU)، تكون مرتبطة مباشرة برئاسة الحكومة (الرئيس الشرع حاليا)، وتضم خبراء في الاقتصاد والإدارة العامة، وتُنسق بين الوزارات لتطبيق أهداف الرؤية.
- تبني مؤشرات أداء وزارية، ومحاسبة دورية للتنفيذ ضمن تقارير فصلية معلنة، كما فعلت الحكومة الماليزية منذ 1983.
- إدخال ثقافة "الحوكمة الذكية" التي تمزج بين الرقمنة والشفافية، مثل نموذج MyGov في ماليزيا، الذي سهّل وصول المواطنين للخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ثالثًا: الاستثمار في الإنسان والتعليم من خلال:
- إعادة بناء منظومة التعليم الفني والمهني في سورية على أساس الربط المباشر بسوق العمل، واستلهام النموذج الماليزي في الجامعات التقنية والمناطق التعليمية الذكية.
- تأسيس جامعات وطنية متخصصة في التنمية والإدارة العامة بالتعاون مع مؤسسات مثل جامعة العلوم الإسلامية العالمية بماليزيا (IIUM)، التي ساهمت في إنتاج كوادر لإدارة التحول الوطني.
- تنفيذ مشروع "مدارس سورية الذكية" في المحافظات النائية، كما فعلت ماليزيا في مناطق صباح وسراواك، لدمج التقنيات الحديثة بالمنهاج الرسمي.
رابعًا: تمكين الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص عبر:
- تبني "سياسة تنمية بالتوازي" التي تمزج بين التحفيز المحلي والاستثمار الخارجي، وتُعطي امتيازات ضريبية للمشاريع التي تُشغّل عمالة سورية وتُصدّر منتجاتها.
- إنشاء مناطق صناعية حرة، مثل "المنطقة السورية–الماليزية المشتركة"، تستوعب استثمارات صناعية وتجارية، مع نموذج تعاوني حكومي–خاص كما في Penang Free Zone.
- تأسيس "هيئة التمكين الاقتصادي للمناطق المتضررة"، تُركّز على دعم المشروعات المحلية الصغيرة، وتُعيد التوازن التنموي بين المناطق.
خامسًا: الانفتاح على التجارب الآسيوية والتحالفات التنموية عبر:
- توسيع العلاقات السورية–الماليزية لتشمل التعاون في الحوكمة، والتعليم، والزراعة، وريادة الأعمال، من خلال اتفاقيات إطار مع وزارة التخطيط الماليزية.
- إطلاق منصة "رؤية آسيا للتنمية السورية"، يُشارك فيها خبراء ماليزيون وإندونيسيون وكوريون جنوبيون، بهدف استلهام نماذج التحول غير الغربي في بناء الدولة.
- توظيف التجربة الماليزية في "إعادة بناء الثقة الوطنية بعد الأزمة"، عبر سياسات ثقافية–إعلامية تروّج للهوية الجامعة، كما فعلت ماليزيا في حملتها "الوحدة الوطنية 1998″.
إن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يعتمد فقط على إعادة الإعمار المادي، بل يحتاج إلى إعادة تصور الدولة نفسها بوصفها بنيةً إنتاجيةً وطنيةً عاقلةً. والتجربة الماليزية، بما فيها من إخفاقات ونجاحات، تقدم دروسًا في تحويل المأزق البنيوي إلى مشروع نهوض، شرط توفر الرؤية، والمؤسسات، والإرادة السياسية الجامعة.
إننا نرى أن التعاون مع ماليزيا ليس ترفًا سياسيًا، بل هو إمكانية واقعية لبناء "جسر إصلاحي" بين ما كانت عليه سورية، وما يمكن أن تكون عليه.
خاتمة: وماذا بعد؟
عند التقاطع التاريخي بين ما واجهته ماليزيا في حقبة ما قبل مهاتير محمد، وما تواجهه سورية اليوم بعد عقد من الانقسام والصراع، يلوح أمامنا نموذج إصلاحي لا يُقاس بحجم الاقتصاد فحسب، بل بقدرة الدولة على إعادة تعريف ذاتها وتوظيف طاقاتها المجتمعية في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية.
إن تجربة التحول الماليزي لا تنتمي فقط إلى الأدبيات التنموية، بل إلى مدرسة فكرية–عملية توازن بين الإرادة السياسية، والاستثمار المؤسسي، والتنوع المجتمعي، وتُراهن على الإنسان بوصفه مركزًا للنهضة.
لقد أثبتت ماليزيا أن دولة خارجة من استعمار وانقسامات إثنية يمكنها، في غضون عقدين، أن تؤسس لهوية مدنية منتجة، وتحقق تراكمًا في رأس المال البشري، وتبني اقتصادًا متينًا يستند إلى الصناعة والمعرفة.
وهذا التحول لم يكن تلقائيًا، بل نتاج قيادة سياسية واعية بالرؤية، وإدارة عامة تتبنى المؤشرات، ومجتمعٍ أعيد توجيه تطلعاته من الهويات الفرعية نحو المشروع الوطني.
أما سورية، فإنها تمتلك من مقومات الحضارة والتنوع والقدرة البشرية ما يؤهلها لخوض تحولٍ مشابه إن توفرت شروط الرؤية والمأسسة والتشاركية.
فلا يكفي أن تستورد السياسات، بل عليها أن تُعيد صياغة منظومتها بما يتلاءم مع بيئتها وسياقها، وتُصمم أدواتها الخاصة مثلما فعلت ماليزيا مع وحدة التخطيط الاقتصادي، والمناطق الصناعية، والشراكات التعليمية.
إن المقاربة التي طرحها هذا المقال لا تدعو إلى "استنساخ مهاتير"، بل إلى "فهم مدرسة مهاتير": المدرسة التي ترى في التنوع فرصة، وفي المواطن ركيزة، وفي السيادة هدفًا يتحقق بالاستقلال الاقتصادي، لا بالشعارات المجردة. وقد آن لسورية أن تخرج من خطاب الأزمة إلى خطاب الرؤية، ومن إدارة الحاضر إلى تخطيط المستقبل، ومن الانغلاق إلى الانفتاح المدروس على تجارب عالمية أثبتت قدرتها على الانتقال من الهشاشة إلى الصلابة.
وما يمكن استلهامه من نهج مهاتير محمد: ليست الدولة من يبني الإنسان، بل الإنسان الواعي هو من يعيد تأسيس دولته.
في ظل هذه الرؤية، فإن سورية أمام فرصة استثنائية: ألا تكون نسخة من التجارب السابقة، بل أن تكتب تجربتها الخاصة كما تحدث الرئيس أحمد الشرع في غير ما مرة، وتبني نهضتها من داخلها، مستفيدةً من الدروس العالمية، دون أن تفقد بوصلتها الوطنية.